- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

لطالما كان الليل هو الملهم الدائم للكتاب والشعراء، في مختلف العصور. ذلك أن أصفى الكلمات وأكثرها دلالة، هي تلك التي ينتشلها الشعراء من عتمة الداخل وقيعانها المترامية. وليس من المستغرب تبعاً ذلك أن يكون الكتاب والمبدعون المكفوفون هم الأكثر قرباً إلى المناجم الحقيقية لاستعارات الكتابة ورموزها المتوارية. ولا بد للقارئ تبعاً لذلك أن يقف مشدوهاً إزاء المخيلة الهائلة للشاعر الإغريقي الأشهر هوميروس، ويعني اسمه الأعمى باليونانية، الذي لم يقف عماه البصري حائلاً دون تفتح بصيرته، وهو الذي قدم للبشرية اثنتين من أفضل الملاحم وأكثرهاً رسوخاً مع الزمن، أعني بهما «الإلياذة» التي أرخت لحرب طروادة، و«الأوديسة» التي تحكي قصة الرحلة المأهولة بالمشقات التي قام بها عوليس إلى مدينته الأم إيثاكا، التي استغرقت عشر سنوات من الزمن. وفي كلتا الملحمتين يستوقفنا البعد المشهدي للوقائع، والوصف الدقيق للمعارك، وللأهوال التي واجهها أبطال خارقون، ومنشطرون بشكلٍ نصفي بين البشر والآلهة.
وإذا كان البعض لا يرون أي غرابة فيما قدمه هوميروس من لوحات شعرية ذات طابع مشهدي، باعتبار أنه أصيب بالعمى في فترة متأخرة، وأن ذاكرته البصرية ما زالت مترعة بالألوان، فإن الأمر يختلف تماماً مع الشاعر العباسي بشار بن برد، الذي حمل عماه مع الولادة، كما يروي المؤرخون. إلا أن من يقرأ نتاج الشاعر لن يستطيع اقتفاء أثر العمى في كتابته، لا بل سيجد نفسه إزاء سبيكة مركبة من الصور الحسية، التي تحتل حاسة البصر موقعاً متقدماً بينها. ونحن لا نعدم الشواهد الكثيرة التي تدل على البعد البصري في شعر بشار، فهو رغم قوله «يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا»، يعود رغم فقدانه البصر ليتحدث عن حور العيون الأنثوية القاتل، في بيته الشهير:
إن العيون التي في طرْفها حورٌ
قتلْننا، ثم لم يحيين قتلانا
إلا أن الشاعر لا ينجح بشكل دائم في إخفاء عقدة العمى تلك، بل إن هذه العقدة ما تلبث أن تظهر في صور مختلفة، كاشفة عن المتاهة الكبرى التي تلف حياته برمتها، وتتركه بلا دليل على طريق الوجود المعتم. وهو ما نستشفه بوضوح من خلال قوله الفريد في وصف الشمس:
والشمس في كبد السماء كأنها أعمى تَحَير، ما لديه قائدُ
كما لا نستطيع في الوقت نفسه أن نغض النظر عن العلاقة بين عمى بشار وبين نزوعه إلى التمرد ورفض الواقع السياسي والاجتماعي القائم في عصره، خصوصاً أنه جعل من الهجاء السياسي والسخرية اللاذعة، طريقته الأثيرة للنيل من خصومه، سواء كانوا في رأس السلطة أو في أسفل الهرم. وإذا كانت الزندقة هي التهمة الأساس التي رُمي بها الشاعر تسويغاً لقتله، فإن السبب الفعلي لمأساته كان سياسياً بامتياز. وفيما عالج بشار بن برد معضلة عماه بالاندفاع نحو الحياة والنهل ما أمكنه من ملذاتها، عن طريق الحواس الأربع الأخرى، انكفأ أبو العلاء المعري بالمقابل إلى داخل نفسه ملازماً بيته في المعرة، حتى أطلق عليه البعض لقب «رهين المحبسين»، وهم يعنون بذلك محبس العمى ومحبس الإقامة. ومع ذلك فإن العطل البصري الذي حرم أبا العلاء من الابتهاج بجمال العالم الخارجي والتلذذ بسحر الألوان، لم ينعكس بالطريقة نفسها على عالمه الداخلي، بل إنه سمح لهذا العالم بالتوهج الكامل، فانقلب إلى حفر عميق في باطن النفس، وإلى اتساع في الأفق المعرفي، وإلى اكتناه حدسي لحقائق الوجود وأسراره.
أما الشاعر اليمني عبد الله البردوني، الذي فقد بصره في الخامسة من عمره، والذي لُقب بمعري اليمن، فهو وإن امتلك بعضاً من حكمة أبي العلاء ونزوعه التأملي، يظل أقرب إلى طرافة بشار وتمرده على الواقع وسخريته الكاريكاتورية والمؤلمة في آن واحد. فالعمى عند البردوني هو الذي جعله يرهف السمع إلى سوس الفساد والاهتراء الذي ينخر عروق اليمن الحديث، كما نخرت الفئران سد مأرب وتسببت بخراب البلاد قبل آلاف الأعوام. واللافت أن صاحب «مدينة الغد»، على غزارة نتاجه، لم يفرد لموضوع عماه أي قصيدة مستقلة، ولم يتعامل مع حرمانه من حاسة البصر بوصفها الخسارة التي يتعذر تعويضها، بل نقل المأساة إلى مكانها الأعم المتعلق بأوضاع بلاده وأمته المزرية، في ظل عمى الحكام، أو تعاميهم المقصود عن رؤية الحقيقة. لا بل يبدو فقدان البصر في قصيدته «الأخضر المغمور» شكلاً من أشكال النعمة، لأن الظلمة بمعناها الرمزي العميق هي الشرط الضروري لتيقظ البصيرة عند البشر، ولانبثاق الحياة في باطن التراب. وهو ما يتمثل في أبياته:
لكي يستهل الصبح من آخر السرى
يحن إلى الأسنى ويعمى لكي يرى
لكي يُنبت الأشجار، يمتد تربة
لكي يصبح الأشجار والخصب والثرى
لكي يستهل المستحيلُ كتابهُ
يمد له عينيهِ حبراً ودفترا
على أن الحرمان من حاسة البصر لم ينعكس بالطريقة نفسها عند الكتاب والمبدعين. فإذا كان بشار والبردوني قد واجهاه بالسخرية والإقبال على الحياة والتمرد على السلطة، وواجهه المعري بالنزوع الفلسفي والانكفاء إلى الداخل، فإن طه حسين لم يعتمد أياً من الخيارين، بل عمل على تجاوز محنته عن طريق تحصيله الأكاديمي، وتعميق ثقافته، وتفاعله مع روح العصر ونزوعه إلى التجديد. وإذا كان صاحب «الأيام» يفترق عن أبي العلاء في رؤيته التشاؤمية إلى الحياة وإيثاره العزلة عن البشر، كطريقة وحيدة للتأمل، أو الفرار من مواجهة الشرور، فهو يلتقي معه في إعلاء العقل وعدم الركون إلى المسلمات واعتماد الشك سبيلاً لا بد منه إلى تلمس اليقين.
من الصعب بالطبع أن نتحدث عن المبدعين العميان دون أن نتوقف قليلاً عند الكاتب الأرجنتيني خورخي بورخيس الذي ورث عن أبيه مشكلة شح البصر، وصولاً إلى إصابته بالعمى الكامل بعيْد منتصف العمر بقليل. إلا أن ذلك لم يمنعه من التحول إلى واحد من العلامات الأدبية والفكرية الفارقة في القرن العشرين. وإذا كان صاحب «كتاب الرمل»، الذي تخيل الفردوس المرتقب على شكل مكتبة كبرى، قد التهم في شبابه كل ما وقعت عليه عيناه من كتب، فهو لم يتوان عن الاستعانة بعدد من الذين تولوا مهمة القراءة له بعد فقدانه البصر، وبين هؤلاء من أصبح بدوره كاتباً مرموقاً، مثل ألبيرتو مانغويل. ومن يتابع كتابات مانغويل اللاحقة، بخاصة عمله اللافت «المكتبة في الليل»، لا بد أن يقف على تأثره الواضح بعوالم بورخيس، الذي نقل عنه مانغويل قوله: «إن من المفارقات الغريبة للقدر، أن يمنحني الله الكتب والليل في آن واحد».
ولعل الليل الذي أشار إليه بورخيس هو بيت القصيد في الكتابة والفن. فالكتابة في جوهرها هي طقس ليلي، لا بالمعنى المباشر لليل الذي يعقب النهار، بل بالمعنى الرمزي الذي يجعل من الإبداع مرادفاً للحب، حيث تُطفأ الأضواء في الحالتين وتُسدَل الستائر، وحيث الإغماض هو السبيل الأمثل إلى الرؤية وانكشاف الحجب. هكذا نقرأ قول البردوني «ويعمى لكي يرى»، أو قول جورج جرداق المماثل «ثم أغمض عينيك حتى تراني». وحين يطلق الشاعر اللبناني صلاح ستيتية على أحد كتبه عنوان «ليل المعنى»، فهو لا يجافي الحقيقة بشيء، حيث كل إبداع حقيقي هو ثمرة تلك العلاقة الجدلية الخاصة بين عتمة المعنى وضوء الشكل. هكذا يصبح العميان من الزاوية الإبداعية أكثر قدرة من المبصرين على التواصل مع المجرى السري للموجودات، حيث اللامرئي هو سيد اللعبة والممسك بزمامها. فالكتاب العميان لا يحتاجون إلى عكاكيز من أي نوع لكي تساعدهم على اجتياز الممر الفاصل بين نثرية الواقع وشعرية التخييل، وهو ما عبر عنه نزار قباني بشكل جلي في رثائه لطه حسين، إذ يخاطبه قائلاً:
ضوءُ عينيكَ أم هما نجمتانِ
كلهمْ لا يَرى، وأنت تراني
ضوءُ عينيكَ أم حوارُ المرايا
أم هما طائران يحترقانِ
إرمِ نظارتيك، ما أنت أعمى
إنما نحن جوقة العميانِ
إلا أن هذا النوع من العمى الحسي الناجم عن فقدان البصر، يختلف تمام الاختلاف عن عمى البصيرة، بشقيه العقلي والروحي. فإذا كان الأول رغم قسوته، يمنح المصاب به فرصة التجول في أكثر مناطق النفس البشرية صلة بالحرية، عبر تحويل العتمة إلى قوس قزح واسع من الرؤى والألوان والكشوف، فإن الثاني يحول الوجود إلى صحراء، والحياة إلى زنزانة ضيقة لا تتسع لغير الظلام المحض والأنا المنكفئة على نفسها، ولغير الخوف من الآخر المختلف. وقد يكون الفارق بينهما شبيهاً إلى حد بعيد بالفارق بين الفن والآيديولوجيا، بخاصة الشمولية منها. وقد يكون جوزيه ساراماغو في روايته «العمى» أحد أفضل الكتاب الذين عبروا عن النوع الثاني والأكثر خطورة. فمدينة العميان المتصارعين في روايته، ليست سوى عالم العصور الحديثة، والعمى الذي يتحول إلى عدوى ليس سوى عمى الآيديولوجيا التمامية التي تحول البشر إلى نوع من «الروبوتات» الفكرية المتشابهة، حيث يتساوى السواد مع البياض في صناعة الكابوس. وحين يعلن ساراماغو بأن العمى هو أن تعيش في عالم انعدم فيه كل أثر للأمل، فهو يجسد مآل هذه الكرة التعيسة في حاضرها الراهن، بقدر ما يجسد هذا المآل قوله في مكان آخر «إن عالم ملاجئ العميان الخيرة والرائعة، قد ولى إلى غير رجعة. ونحن الآن في مملكة العميان القاسية، والوحشية والمليئة بالأحقاد».
المقالات
كتابات وآراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر


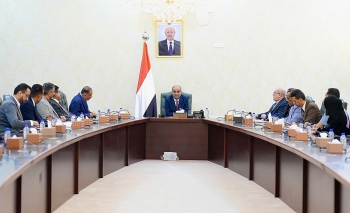

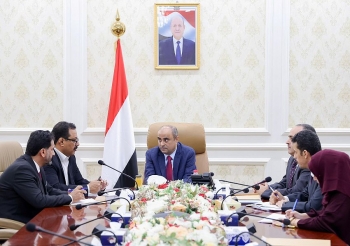














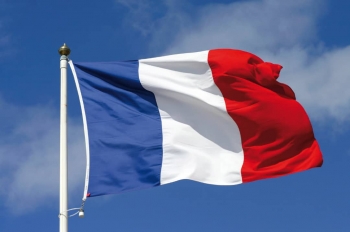









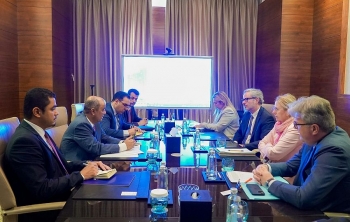





 2024... عام «تمكين» الثقافة السعودية
2024... عام «تمكين» الثقافة السعودية مجلات الأطفال العربية... تحت اختبار الرقمنة
مجلات الأطفال العربية... تحت اختبار الرقمنة قراءة في رواية «احمي قلبك» للكاتبة الايرلندية «سو ديفين»
قراءة في رواية «احمي قلبك» للكاتبة الايرلندية «سو ديفين» اقرأ معي! دور سرد القصص للأطفال في تعلم القراءة
اقرأ معي! دور سرد القصص للأطفال في تعلم القراءة اليونسكو تنعي المعماري "الفائز بمسابقة إعادة بناء جامع النوري" بالموصل
اليونسكو تنعي المعماري "الفائز بمسابقة إعادة بناء جامع النوري" بالموصل من الصين إلى المطبعة الأوروبية.. كيف نقل المسلمون أسرار صناعة الورق ومهدوا لثورة الطباعة؟
من الصين إلى المطبعة الأوروبية.. كيف نقل المسلمون أسرار صناعة الورق ومهدوا لثورة الطباعة؟



















